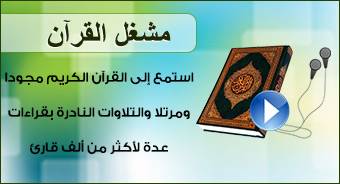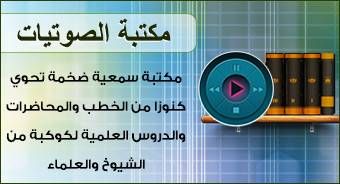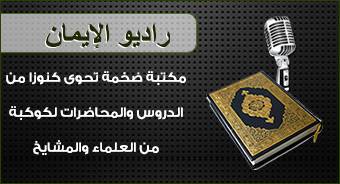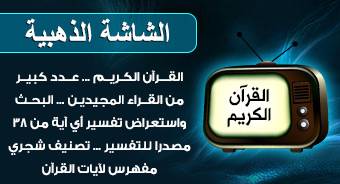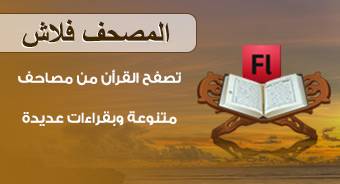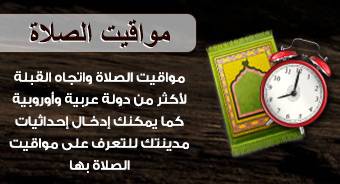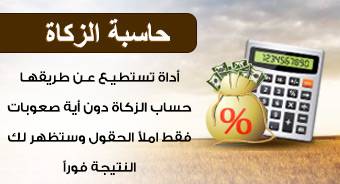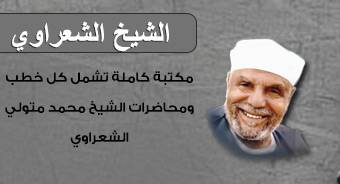|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
- أول ما ينتج كانوا يذبحونها لآلهتهم. - ذبيحة كانت تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون فنسخ ذلك. قال الأزهري: العتيرة في رجب، وذلك أن العرب في الجاهلية كانت إذا طلب أحدهم أمرا نذر: إن ظفر به ليذبحن من غنمه في رجب كذا وكذا، فإذا ظفر به، فربما ضاقت نفسه عن ذلك وضنّ بغنمه، فيأخذ عددها ظباء فيذبحها في رجب مكان تلك الغنم فكأن تلك عتائره. وفي الحديث أنه صلّى الله عليه وسلم قال: «لا فرع ولا عتيرة». [البخاري 7/ 110]. وقد انفرد ابن يونس من المالكية بتفسير خاص، قال: العتيرة: الطعام الذي يبعث لأهل الميت. قال مالك رضي الله عنه: أكره أن يرسل لمناحة، واستبعده غيره من فقهاء المالكية. [المعجم الوسيط (عتر) 2/ 603، والموسوعة الفقهية 29/ 277].
والعتيق: القديم والكريم، وثوب عتيق: جيد الحياكة. والبيت العتيق: الكعبة، والعتيق من الخيل: النجائب، والعتاق من الطير: الجوارح، والجمع: عتق وعتاق. [المعجم الوسيط (عتق) 2/ 604، والنظم المستعذب 2/ 54، والمغني لابن باطيش 1/ 413].
وأما الغيل والغلل: فهو الماء الجاري على وجه الأرض. [الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 169، ونيل الأوطار 4/ 140].
الشمراخ، وهي في النخل بمنزلة العنقود في الكرم، والله تعالى أعلم. [المصباح المنير (عثكل) ص 392 (علمية)، والمطلع ص 370].
- شعيرات طوال عند مذبح البعير والتيس. - ما تدلى تحت منقار الدّيك، والجمع: عثانين. [المعجم الوسيط (عثن) ص 605، والموسوعة الفقهية 25/ 317].
العجاجيل، وقيل: العجل: ولد البقرة حين يوضع، ثمَّ هو برغز، ثمَّ فرقد. [المصباح المنير (عجل) ص 394 (علمية)، والمطلع ص 283].
وفي بعض العبارات: الاعتجار: لف العمامة دون التلحي. وروى عن النبي صلّى الله عليه وسلم: «أنه دخل مكة يوم الفتح معتجرا بعمامة سوداء». [النهاية 3/ 185]. المعنى: أنه لفها على رأسه ولم يتلح بها. [المصباح المنير (عجر) ص 393 (علمية)، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 85].
حمد النفس. قال الراغب الأصفهاني: العجب: ظن الإنسان في نفسه استحقاق منزلة هو غير مستحق لها. وقال الغزالي: العجب: هو استعظام النعمة والركون إليها، مع نسيان إضافتها إلى المنعم. قال ابن عبد السلام: العجب: فرحة في النفس بإضافة العمل إليها وحمدها عليه مع نسيان أن الله تعالى هو المنعم به، والمتفضل بالتوفيق إليه، ومن فرح بذلك لكونه من الله تعالى واستعظمه لما يرجو عليه من ثوابه ولم يضفه إلى نفسه ولم يحمدها عليه فليس بمعجب. وعجب الذّنب:- بعين مهملة وجيم موحدة-: هو أصل الذنب، وهو الذي في أسفل الصلب عند العجز، وهو العسيب من الدواب. [المغني لابن باطيش 1/ 306، والمطلع ص 368، والموسوعة الفقهية 2/ 319، 29/ 280].
والثّجّ: سيلان الدم من الهدايا والضحايا. وفي الحديث: «أفضل الحج العج والثج». [الترمذي- الحج 14]. [التوقيف ص 504، والمغني لابن باطيش 1/ 265].
وفي (المصباح): أعجزه الشيء: فاته. وفي (مفردات الراغب): العجز: أصله التأخر عن الشيء، وصار في التعارف اسما للقصور عن فعل الشيء، وهو ضد القدرة. وفي الاصطلاح: قال الرافعي: لا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط، بل في معناه خوف الهلاك، والذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحق مشقة تذهب خشوعه. وقال أهل الأصول: العجز: صفة وجودية تقابل القدرة وتقابل العدم والملكة. ويقول الأصوليون: جواز التكليف مبنى على القدرة التي يوجد بها الفعل المأمور به، وهذا شرط في أداء حكم كل أمر، حتى أجمعوا على أن الطهارة بالماء لا تجب على العاجز عنها ببدنه، بأنه لم يقدر على استعماله حقيقة، ولا على من عجز عن استعماله إلا بنقصان يحل به، أو مرض يزاد به. [المصباح المنير (عجز) ص 393، 394 (علمية)، والتوقيف ص 504، والموسوعة الفقهية 29/ 284].
والعجف: الهزال: ضد السمين. [المصباح المنير (عجف) 3941 (علمية)، والإقناع 4/ 51].
ويقال: (لسان أعجمي): إذا كان في لسانه عجمة، وعلى ذلك فالعجمية والعجمية خلاف العربية. والعجم: صغار الإبل وفتيانها، والجمع: عجوم. [لسان العرب (عجم) 2828، والموسوعة الفقهية 30/ 35].
والأعجم أيضا: الذي لا يفصح ولا يبين كلامه، وإن كان من العرب، وقد سبق ذكره، والمرأة عجماء. وتطلق العجماء والمستعجم على كل بهيمة، كما ورد في (اللسان): «صلاة النهار عجماء». [كشف الخفاء 2/ 37] بالمد، سميت بذلك، لأنها لا يسمع فيها قراءة، قاله أبو عبيد. وفي الاصطلاح: عرف بعض الفقهاء العجماء: بأنها البهيمة. وفي الحديث: «العجماء جرحها جبار». [النهاية 3/ 87]. [لسان العرب (عجم) 2827، والمغني لابن باطيش 1/ 118، ونيل الأوطار 4/ 1047، والموسوعة الفقهية 29/ 292].
[تحرير التنبيه ص 202، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1148، وفتح الباري (مقدمة) ص 162].
وروى عن يونس أنه قال: سمعت العرب تقول: عجوزة- بالهاء-، والجمع: عجائز وعجز. [المصباح المنير (عجز) ص 393، 394 (علمية)، والموسوعة الفقهية 29/ 294].
قال الشاعر: [النظم المستعذب 2/ 93].
وفي الشريعة: عبارة عن الاستقامة على الطريق الحق بالاختيار عما هو محظور دينا، وهي نوعان: الأول: ظاهرة: وهي ما تثبت بظاهر العقل والدين، لأنهما يحملانه على الاستقامة، ويزجرانه عن غيرها ظاهرا. الثاني: باطنة: وهي لا يدرك مداها، لأنها تتفاوت فاعتبر ذلك ما لا يؤدى إلى الحرج والمشقة وتضييع حدود الشرع، وهو ما ظهر بالتجربة رجحان جهة الدين والعقل عن طريق الهوى والشهوة بالاجتناب عن الكبائر وترك الإصرار على الصغائر. قال ابن عرفة بعد أن أشار إلى كلام أهل الأصول والفقهاء وتنبيههم عليها: لأنها شرط في الشهادة والخبر. ولذا عرّفها ابن الحاجب في كتابيه: الأولى: صفة مظنة لمنع موصوفها البدعة وما يشينه عرفا ومعصية غير قليل الصغائر. قال المناوي: العدالة: الاستقامة في طريق الحق بتجنب ما هو محظور في دينه، وقيل: صفة توجب مراعاتها التحرز عما يخل بالمروءة عادة ظاهرا، فالمرّة الواحدة من صغائر الهفوات وتحريف الكلام لا تخل بالمروءة ظاهرا، لاحتمال الغلط والسهو والتأويل بخلاف ما إذا عرف منه ذلك وتكرر فيكون الظاهر الإخلال، ويعتبر عرف كل شخص وما يعتاد في لبسه، كذا في (المفردات). وفي (جمع الجوامع) وشرحه: العدالة: ملكة راسخة في النفس تمنع عن اقتراف كل فرد من الكبائر وصغائر الخسّة كسرقة لقمة وتطفيف ثمرة، والرذائل الجائزة كبول بطريق، وأكل غير سوقي به. [المصباح المنير (عدل) ص 396 (علمية)، والمطلع ص 408، والكليات ص 640، وشرح حدود ابن عرفة ص 588، والتوقيف ص 505، والواضح في أصول الفقه ص 111، والموسوعة الفقهية 29/ 298]. |